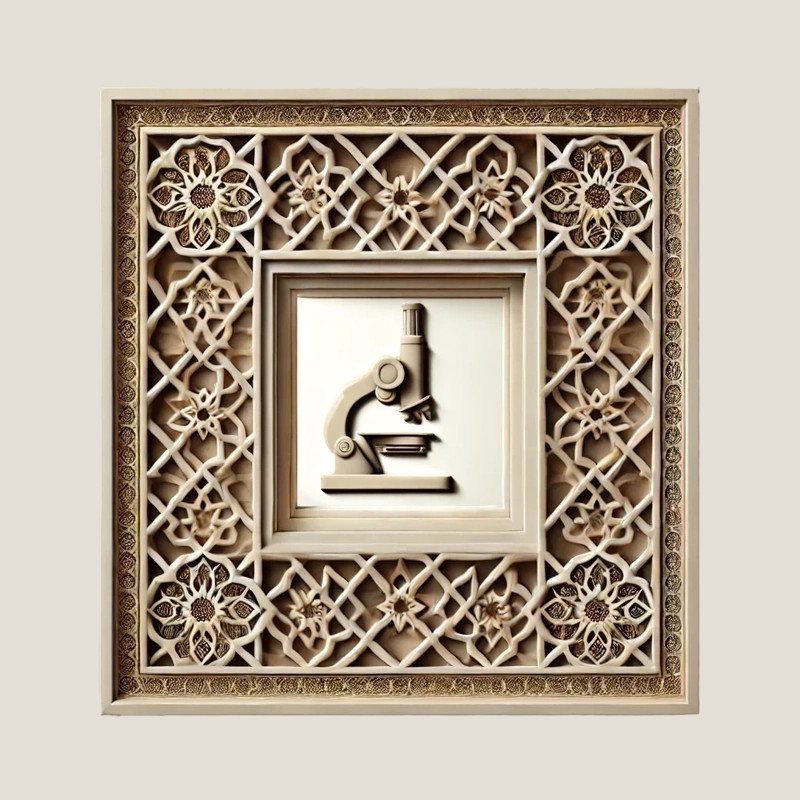علم الاجتماعي الاسلامي و نقد علم الإجتماع من منظور اسلامي
باعتراف علماء الاجتماع أنفسهم، “علم الاجتماع” في القرن العشرين، أبتعد كثيراً عن الحيادية والنزاهة وأصبح يعتمد على بعض المبادئ الخفية في أبحاثه، ففكرة معرفة السلوك الاجتماعي في هذا العلم تحول الى نظرية التحكم بالسلوك الاجتماعي و فكرة نقد السلوكيات الاجتماعية تحول الى نظرية “بديهية فشل جميع المعتقدات السابقة” وفكرة الدراسات الحرة والمتحررة والأبحاث العلمية أصبحت لعبة بيد الرأسماليين الممولين لمراكز الأبحاث. علم الاجتماع أصبح علم مسيس وموجه وملغوم وأصبح لا يوجد شيء إسمه علم محايد وأصول محايدة و جميع الابحاث أصبحت تعتمد على احصائيات شركات خاصة غير بريئة وفي الواقع شركات الاحصاء و المؤسسات الاعلامية أصبحت تتحكم بانتاجات علم الاجتماع .لكن من جهة أخرى ما يعرف بإسم العلوم الاجتماعية الاسلامية أيضا اليوم تنطبق على مجتمعات مثالية وظروف بعيدة كل البعد عن واقعنا وعن ظروفنا الحالي وعن مجتمعنا الحالي وكذلك السلوك الاجتماعي للمسلمين اليوم بعيدة كل البعد عن الاسلام والقرآن والشريعة، رغم إننا نؤمن بأن وحدهم محبي أهلي البيت يتجلي عندهم الاسلام الحقيقي وغيرالمحرف كما ورد في حديث الثقلين و حديث الفرقة الناجية في الاسلام.
القرن العشرين شاهدنا ولادة الديانة العلمانية الخادعة والمتعصبة وبعض مضاهرها الخادعة تشمل مفهوم الحريات الإفراطية والمتوحشة على الأنفس البشرية لصالح دولة الظل الرأسمالية ومفهوم المساوات الأعمى ضد التنوع الطبيعي للمخلوقات، و نسبية الحقيقة والحق أمام ثبات الباطل وهيمنة الفرضيات والنظريات العلمية على كل شيء، رغم فشل العلم في تأمين السعادة البشرية في كل الدنيا، كأهم اختبار لحقانية أي مدرسة علمية في علم الاجتماع. فالرفاهية في الغرب هي في الواقع ناتجة عن استعمار عالم الثالث لقرون متمادية و سرقة مصادرهم وثرواتهم وليس نابعة عن تجلي النظريات العلمية في علم النفس خلال القرن الماضي الذي شهد حربين عالميين راح ضحيتهما ملايين الاشخاص. تجلى نظريات الاسلامية في المجتمع يحتاج فقط الى شرطين ولا يكفي الايمان الفردي ولا يكفي فيه تاسيس وتشكيل الدولة الاسلامية، الشرطان هما الايمان بالشريعة والتحاق غالبية الناس أي اكثرهم الى هذا المجتمع بعقيدة ويقين كاملتين حتي يتحقق افضل ظروف للتكامل والكمال العام.
نشأة علم الاجتماع:
يذكر بعض المؤرخين لعلم الاجتماع، أن له أربعة أصول فكرية، تتمثل في : ” الفلسفة السياسية وفلسفة التاريخ والنظريات البيولوجية في التطور وتاريخ الحركات التي قامت تنادي بالإصلاح الاجتماعي والسياسي، ووجدت أنه من الضروري أن تجري لهذا الغرض دراسات مسحية للظروف الاجتماعية ”
وعلى كل حال، فإن “أوجست كونت” الفرنسي إضافة إلى وضعه لاسم علم الاجتماع، فقد دعا إلى الدراسة الوضعية للظواهر الاجتماعية، ووضع الفيزياء الاجتماعية على رأس العلوم قاطبة، وقد عني بعلم الاجتماع والفيزياء الاجتماعية ” ذلك العلم الذي يتخذ من الظواهر الاجتماعية موضوعا لدراسته، باعتبار هـذه الظواهر من روح الظواهر الفلكية، والطبيعية، والكيماوية والفسيولوجية نفسها، من حيث كونها موضوعا للقوانين الطبيعية الثابتة ”
ويعد “هـربرت سبنسر” الإنجليزي، أحد رواد علم الاجتماع المعاصرين لكونت. وقد أدرك إمكانية تأسيس علم الاجتماع، وأخرج مؤلفات متعددة في هـذا العلم ” كالاستاتيكا الاجتماعية، و “دراسة علم الاجتماع” و “مبادئ علم الاجتماع ” . وقد سيطرت عليه فكرة التطور الاجتماعي المستمر عبر الزمان، وهو من رواد “الفكر التطوري والحداثوي” . كما أن ماركس الذي يعد القائد الأول للحركة العمالية الثورية، قدم وجهات نظر وآراء تعد داخلة في علم الاجتماع، بالمعنى الحديث، وقد أصبح أبا فيما بعد لعلم الاجتماع الماركسي، الذي تعد “المادية التاريخية” أساسا له.
كما أن الحديث عن نشأة علم الاجتماع، لا بد أن يتطرق إلى فلسفة التنوير العقلانية النقدية، التي أثارت كثيرا من مسائل علم الاجتماع، ثم بعد ذلك، الموقف منها، هـل هـو: موقف المتقبل، كما هـو الحال في علم الاجتماع الماركسي. أو موقف الرافض، كما هـو الحال في علم الاجتماع المحافظ؟ أو موقف الموفق بينها وبين غيرها من الأفكار المعارضة؟
كما أن آثار الثورة الصناعية، والثورة الفرنسية، مهدت الطريق بشكل مباشر لتطور علم الاجتماع، حيث أفرزتا الكثير من المشاكل التي تبحث عن حل.
علم الإجتماع، التناقض في المبادئ و نظريات متعارضة
مستوحاة من مقال “علم الاجتماع: غبش في التصوّر وتشوّش في النظرية” للدكتور أحمد إبراهيم خضر من جامعة القاهرة مصر (بلد الماسونية والاستعمار الثقافي).
أولاً: التناقض فی المبادئ:
أوَّل ما يتعلَّمه الطالب بقسم الاجتماع بالجامعة هو أنَّ هناك نظامًا كامنًا في الطبيعة، وأنَّ علم الاجتماع يَسعَى إلى اكتِشاف ووصْف وتفسير النظام الذي يُميِّز الحياة الاجتماعيَّة للإنسان، يتعلَّم من الأساتِذة أنَّ الأحداث تَتِمُّ في شكلٍ مُتَتابع مُنتَظِم؛ حيث يُمكِن صِياغة أحكامٍ قابلة للتَّجرِبة حول علاقة حادثةٍ بحادثة أخرى عند نُقطةٍ مُعيَّنة من الزمن وتحت ظروفٍ مُحدَّدة، يتعلَّم من أساتِذته أنَّ الناس في حَياتهم اليوميَّة يَقُومون بملايين الأفعال الاجتماعيَّة وهم يَتفاعَلون مع بَعضِهم البعض، وأنَّ هذا الكمَّ الهائل من الأفعال لا يُؤدِّي إلى الفَوضَى والاضطراب؛ بل يُؤدِّي إلى ظُهور ضَرْبٍ من النِّظام يَتمكَّن الفرد بِمُقتَضاه من أنْ يحقِّق أهدافه دُون أنْ يَتداخَل أو يَتضارَب مع أهداف الآخَرين، يتعلَّم من أساتِذته أنَّ مهمَّة علم الاجتماع تنحَصِر في الوُقوف على كيفيَّة حُدوث ذلك، وكيف أنَّ التنسيق بين الأفعال المتنوِّعة الصادرة من الأفراد يُؤدِّي إلى تدفُّق الحياة الاجتماعيَّة واستِمرارها، وكيف يمكن التخلُّص من حالة الاضطراب والصِّراع الناتجة عن مُحاوَلة تحقيق بعض الناس أهدافهم على حِساب الآخَرين.
يتعلَّم من أساتذته أنَّه ليس من شأن علم الاجتماع أنْ يضع برنامجًا لرفاهية الناس، وأنَّه ليس نظريةً للإصلاح الاجتماعي، وأنَّه ليس قانونًا للأخلاق، إنَّه – فقط – منهجٌ متخصِّص ووجهة نظَر مشابهة لتلك التي للعلوم الطبيعيَّة، إنَّه يُحلِّل الظواهر التي تَنشَأ نتيجةً لحياة البشر ويُفسِّرها، وإنَّه لا يضَع أحكامًا قيميَّة، ولا يضَع مستويات للسلوك الإنساني، إنَّه لا يَستَحسِن ولا يُدِين سياسة معيَّنة أو برنامجًا خاصًّا، ولكنَّه يصف ببساطةٍ العلاقةَ بين العلَّة والمعلول ويُحلِّلها، إنَّه يبحث فيما هو كائنٌ، ويترك ما يجب أنْ يكون لِمَن يهتمُّون بالجانب الأخلاقي والمشكلات الاجتماعيَّة.
ينجذَبْ الطالب إلى بريق علم الاجتماع – كجميع طلاَّب علم الاجتماع في العالم – على أمَل أنْ يُساعِدهم هذا العلمُ على فهْم أسباب فَوضَى الحياة الاجتماعيَّة المُعاصِرة، وعلى أمَل أنْ يجدوا فيه حُلولاً للمشكلات الاجتماعيَّة التي يُعانِي منها المجتمع، والآن وبعد ثلاثين سنة أكمَلناها في دِراسة وتَدرِيس علم الاجتماع اكتَشَفنا أنَّ كلَّ ذلك كان سَرابًا في سراب.
لم يستطع علم الاجتماع أنْ يُحقِّق أمانينا منذ كنَّا طلابًا وحتى الآن؛ لا في فهْم أسباب فوضى الحياة الاجتماعية، ولا في تقديم ولو حلاًّ واحدًا لمشكلةٍ واحدةٍ يُعانِي منها مجتمعنا.
اكتشَفْنا أنَّ العلوم الاجتماعيَّة برُمَّتها ما هي إلا علومٌ أوربيَّة الصُّنع، وأنها عجزت – في بلادها – عن إثارة القَضايا المتَّصلة بصَمِيم وُجود الإنسان، اكتشفنا أنَّ ما درَسْناه لم يكنْ أكثر من مجرَّد أفكار فلسفيَّة، وقيم ومواقف أخلاقيَّة، تخصُّ مجتمعات وثَقافات تختَلِف عنَّا، لقَّنَها له أساتذته تحت سِتار العِلم وباسم المنهج العلمي، كانو يدرسون نظريَّات لم تكن منفصلةً – أبدًا – عن التحيُّزات العنصريَّة والفرديَّة لأصحابها، وباسم الالتزام بالمنهج العلمي كان علينا أنْ نَقبَل هذه النظريَّات كمُسلَّمات، لم تكن أبدًا خاضعةً لتمحيصٍ علمي، بل كانت مُستَمدَّة في معظمها من الحدْس والتخمين والانعِكاسات الشخصيَّة لواقع مُنظِّريها، أساتذتنا حوَّلونا إلى أجيالٍ ذليلة تابعة تافهة، فسكرت أبصارنا، وبلغت بنا السطحيَّة والغَفلة إلى أنْ نقول: إنَّ تراث الغرب ليس ملكًا للغرب وحدَه، إنما هو تراث الإنسانيَّة، ومن حقِّنا أنْ نأخُذ منه كما سبَق أنْ أسهَمْنا في بنائه.
قيل لهم إنَّ هناك عُموميَّات تجمَعُ بين المجتمعات البشريَّة تسمح لنا باستخدام مَقُولات وأفكار وأدوات ظهَرتْ في غير مجتمعاتنا وغير ثقافتنا، إلى أنِ اكتَشَفنا بعد حينٍ أنَّ العُلوم الاجتماعيَّة علومٌ عقديَّة تحمل فِكرًا مُعيَّنًا، وأيديولوجيَّة خاصَّة تُعادِينا أو تَزدَرِينا في أحسن الأحوال، وتُحرِّضنا على احتِقار ثَقافتنا، وترغمنا على الاعتِقاد بأنَّنا أدنى، تقول لنا: إنَّهم هم الكعبة وهم النموذج الوحيد للتقدُّم، وما علينا إلاَّ أن نتبعهم طواعيةً واختيارًا، وإلا فستظهر لعلومهم الاجتماعيَّة أنيابها الحادَّة، فهي علومٌ لا يعرف الجهلاء منَّا أنها محميَّة بقوَّةٍ مسلَّحةٍ.
يقول البعض: “إنَّ علم الاجتماع هو العلم الذي يأخُذ ما يفهمه كلُّ واحد منَّا، ويصوغُه في عباراتٍ لا يفهمها أيُّ أحد منَّا”، وذاك يقول: “إنَّ عُلَماء الاجتماع لا يفعَلُون أكثر من التعبير عن كلِّ ما هو واضح بطريقةٍ مُعقَّدة وغامضة”،
في الواقع لم يستطع علم الاجتماع أنْ يُقدِّم لنا صورةً كاملة وشاملة للإنسان والمجتمع، لم يُقدِّم لنا إلا وجهة نظر مُعيَّنة – من بين وجهات نظَر عديدة – وهي وجهة نظَر محدودة ومُحدَّدة، المشتَغِلون بعلم الاجتماع يُدرِكون دائمًا نسبيَّة وقُصور آرائهم، ونسبيَّة التساؤلات التي يطرحونها، ويُدرِكون أيضًا قُصور الإجابات التي يعتقدون أنهم انتهوا إليها.
عُلَماء الاجتماع صِنفان: مُنظِّرون خياليُّون يعيشون في بُروجٍ عاجية، لا يَعرِفون شيئًا عن العالم المحيط بهم، بعيدون عن الواقع الحقيقي للمجتمع، وجامعو بيانات ينفذون بحوثًا لحِساب الآخَرين نظير مقابل مادي، لا يلتزمون بأيِّ قيمةٍ حتى القِيَم التي يتذرَّعون بها، وكل عُلَماء الاجتماع يعملون داخل نسيجٍ اجتماعي مُفتَّت كانوا هم أحدَ عمد تخريبه، وجامعات مشلولة لم تستطع أنْ تخرج عن الدور المرسوم لها.
علم الاجتماع كفرعٍ أو تخصُّص علمي – كما يعتَقِد أصحابُه – ليس إلاَّ مجموعة من المشكلات المتراصَّة جنبًا إلى جنبٍ دون وُجود علاقة عميقة تربط بينها.
ثانيًا: نظريّات موجهة:
حينما بدَأنا نخطو الخطوات الأولى في مرحلة الدراسات العليا، كانت هُناك مقولاتٌ تعلَّمناها وقرأناها واستَوْعبناها، وكان علينا أنْ نسيرَ على هديِها في طريقنا الطويل نحو الماجستير والدكتوراه.
قرَأنا لعالِمٍ اجتماعي أمريكي: “إنَّ النظريَّة بالنسبة لعلماء الاجتماع كالدِّين بالنسبة للجمهور”، ثم تعلَّمنا أنَّ على علم الاجتماع أنْ يتَّجِه نحو صِياغة نظرية قادِرة على توليد حُلول اجتماعيَّة للمشكلات الإنسانيَّة.
علَّمَنا أساتذتنا أنَّ حلَّ مشاكل المجتمع غير ممكنٍ إلا في حالة واحدة؛ وهي: أنْ يستند الحل دائمًا إلى أطارٍ دقيقٍ من المفاهيم العلميَّة ذات الاتجاه النظري الواضح، قالوا لنا: إنَّ النظرية هي التي تحدُّ الحدود، وتُقِيم الفواصل، وتُعطِي للبيانات معنًى، قالوا لنا: إنَّ البحث دُون سند من نظرية أو اتجاه ليس إلا نوعًا من العبَث؛ لأنَّ النظريَّة تُمكِّن الباحث من فهْم المجتمع في صُورته الكلية، وتُعطِيه إطارًا للبحث في مناطق محدودة متَّسقة مع الصورة التي استَمدَّها من النظريَّة، وإنَّ البحث إذا لم يجرِ في إطارٍ فكري محدَّد فإنَّه سيكونُ محاولة عقيمة لا تتقدَّم خطوة في فهْم المجتمع.
علَّمَنا أساتذتُنا أنَّ النظريَّة يجب أنْ تتوافر فيها عدَّة شروط؛ منها: استنادُ قَضاياها إلى أفكارٍ محدَّدة، واتِّساق هذه القضايا الواحدة مع الأخرى بحيث يمكن أن تُستَقرأ منها تعميمات، وأنْ تكون هذه القضايا منتجة؛ حيث تقود إلى مزيدٍ من الملاحظات التي توسع نِطاق المعرفة.
طرَحنا الدِّين والعقيدة جانبًا وبدَأنا البحثَ عن هذه النظرية وقَضاياها ومفاهيمها؛ فإذا بنا أمامَ بناءٍ هَشٍّ مهلهل صُوِّر لنا على أنَّه علم، كان أوَّل ما اصطدمنا به أنَّنا وجدنا علم الاجتماع يتحدَّث بحرارةٍ عن النظرية، وعن فائدة النظرية، ولَمَّا سعينا لنعرف ما المقصود بالنظرية واجهَتْنا تعريفاتٌ متضاربة وغامضة في أحسن الأحوال.
كان من الصعب علينا أنْ نجد اتِّفاقًا بين علماء الاجتماع على نظرية واحدة، أو على تفسيراتٍ محدَّدة لما يتحدَّثون عنه، لقد كانوا مختلفين على أوَّل مفهومٍ يجب أنْ يتَّفقوا عليه، وهو: (مفهوم المجتمع)، لم نجد بناءا فكريًّا متماسكًا يمكن أنْ نضع إصبعنا عليه، ومنذ أعوامنا الأولى في طريقنا في هذا العِلم نجدُ مَن يُشبِّه لنا المجتمع بالكائن الحي، وآخَر يُصوِّره لنا على أنَّه آلة تدُور بفعل مجموعةٍ من الطاقات المتحرِّكة، وكأنَّنا نتعامَل مع الميكانيكا، وثالث يُصوِّر لنا الحياة الاجتماعية في ضوء العوامل الاقتصادية، ورابع يُفسِّرها في ضوء العوامل النفسيَّة، وخامس يتحدَّث عن العوامل الجغرافية، وسادسٌ له الغلبة على الساحة فيُصوِّرها لنا على أنها قصص من قصص الصراع يتغلَّب فيها فريقٌ على آخَر، ويتبادَلان الهزيمة والانتصار في دورةٍ محدَّدة من الزمان، تتعاقَب فيها سلسلةٌ متَّصلة من الحلقات… وهكذا، ومعظم مَن كتبوا في علم الاجتماع كانوا قد فشلوا في تخصُّصاتهم الأصلية، فدخَلُوا ميدانهم الجديد بتصوُّراتهم القديمة.
يعجُّ العلم الآن بالتصوُّرات المتناقضة؛ هذا من مدرسة شيكاغو، وذاك من مدرسة فرانكفورت، هذا ماركسي أصولي، وذاك ماركسي جديد، هذا ظاهراتي، وذاك إثنوميثودولوجي، وهكذا… هناك حشْد هائل من الآراء والنظريَّات في علم الاجتماع، هذه الآراء والنظريَّات ليست مختلفةً فقط، ولكنها متضاربة ومتصارعة أيضًا، القَضايا التي تبحثُ فيها هذه النظريَّات غير متجانسة، المفاهيم التي هي المادة الأوَّليَّة في بناء أيِّ نظريةٍ ليس هناك اتِّفاق عليها، كلُّ نظرية تضمُّ اتِّجاهات فرعيَّة، وكلُّ اتجاه فرعي يحشد مفاهيم ومصطلحات مختلفة لشيءٍ واحد أو متَّفقة لأشياء مختلفة، وهي في جميعها تختلف اختلافًا كبيرًا على المناهج المناسبة التي يمكن استخدامها في الحصول على المعرفة الواقعيَّة أو تنظيمها.
حقائق مهمَّة عن العلوم والنظريَّات الاجتماعية
ويعتَرِف العلماء الاجتماعيون بعدَّة حقائق مهمَّة عن العلوم والنظريَّات الاجتماعية، نوردها هنا على النحو التالي:
الأولى: أنَّ الحقل المعرفي الذي تطوَّرت فيه نظريَّات علم الاجتماع حقلٌ راعَى ما يسمَّى بقواعد اللعبة المشتركة والمقبولة ضمنيًّا من الجميع، والتي أوجدت حيِّزًا مكانيًّا مُشترَكًا لجميع الفرقاء
الثانية: وننقلها هنا على لسان علماء الاجتماع الأمريكيين:
“تنطلق النظريَّات والنماذج والمنظورات الخاصَّة بعلم الاجتماع من داخل الأبنية العامَّة للمجتمعات الرأسماليَّة… وعلماء الاجتماع في هذه الأبنية يعيشون أصلاً في (سوق أكاديمي) يشتدُّ فيه الصراع على الهيبة والعُمَلاء والمستَمِعين، ولا بُدَّ في هذه السوق من الابتكار والاختراع لضَمان السوق والعملاء، ومن ثَمَّ لن يبقى في هذه السوق أصحاب النظريَّات والآراء القديمة؛ فالسوق لا يعيش بأفكار الأمس، بل بالأفكار الجديدة التي تُعطِي الهيبة، وتفتح مجالات ومؤتمرات ومراكز بحث وأقسام جديدة، إنَّ هذه الأفكار والآراء والنماذج الجديدة ليست بحثًا نبيلاً عن الحقيقة، إنها بحثٌ عن الهيبة والوظيفة والعُمَلاء”.
الثالثة: أنَّ الشك في قيمة وجَدوَى العلوم الاجتماعية قد زاد في السنوات الأخيرة، وأنَّ المشتغِلين بهذه العلوم لم تكن لهم القُدرة على متابعة الأحداث المهمَّة، لا في مجتمعاتهم ولا عبر العالم، كما أنَّ قلَّة العائد الملموس من هذه العلوم لم يُمكِّن أصحابَها من تدعيم مركزهم أو إقناع حُكوماتهم بجدوى بحوثهم التي يشوبُها الجدل والافتراضات والتعميمات الفضفاضة التي لا تستند إلى أساسٍ مَتِين من الواقع، وقد أدَّى الشكُّ في هذه العلوم إلى زيادة حدَّة السخرية والتهكُّم اللاذع عليها باتِّهام العلماء الاجتماعيين بأنهم يقضون ربع قرنٍ من حياتهم للبرهنة على حقائق يعرفها الناس من أجْل إعطائها الصبغة العلميَّة.
الرابعة: أنَّ العلوم الاجتماعية ليست علومًا عالميَّة، ولا يمكن القول بأنَّ نتائجها ذات مصداقيَّة عالميَّة؛ لأنها لم تُجرَب إلا على الغرب الحديث، كما أنها لا تستند إلى قاعدةٍ كافية من المعلومات عن سائر المجتمعات البشريَّة؛ ولهذا فإنَّ نظريَّاتها لا تنطبق إلا على مجتمعات الغرب فقط.
الخامسة: أنَّ قادة الفِكر الغربي في العلوم الاجتماعية انطلقوا من مبدأ تفوُّق واستعلاء الغرب على العالم، وكان مفهوم التفوُّق الغربي مسلَّمة أساسيَّة عندهم، والذين حاوَلوا منهم إنصاف الإسلام مثل (رودنسون)، كان يستهدف القول للمسلمين بأنَّ الإسلام إنْ كان صالحًا للماضي فهو غير صالحٍ الآن.
السادسة: أنَّ العلوم الاجتماعية الغربية ارتبطت ارتباطًا مباشرًا بالدولة ومُخطَّطاتها؛ ولهذا فإنَّ النظريَّات الغربية سارت وفْق مخطط السيطرة الغربية على النظام العالمي، وعلى أساس مسلَّمة تفوُّق الغرب، وأنَّ الحضارة الغربية هي الغاية الوحيدة للتقدُّم العالمي المنشود؛ ولهذا لا بُدَّ من سِيادة أفكاره، ومشروعيَّة سَيْطرته على العالم.
السابعة: أنَّ الكثير من الدراسات الاجتماعية يتمُّ بتوجيهٍ من إدارات المخابرات في الدول المختلفة، ولا سيَّما المخابرات الأمريكيَّة التي تُسخِّر أعدادًا من المتخصِّصين للقيام بدِراسات معيَّنة ليس في أمريكا وحدَها بل في العالم كله؛ بغرض التنبُّؤ والتكهُّن، ثم التحكُّم والتوجيه والإدارة بما يتَّفق مع المصالح العسكريَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة الغربيَّة.
المصدر: حلقات من كتاب (اعترافات علماء الاجتماع، عقم النظرية وقصور المنهج في علم الاجتماع).
مبادئ واصول علم الاجتماع الاسلامي :
العلوم الانسانية الاسلامية لا تتجلى فقط من خلال تصحيح الانحراف والانحياز في مبادئ العلوم الانسانية الغربية ومصارها ولا تنشأ من خلال ادخال مفاهيم دينية بديلة من المفاهيم العلمية او غير العلمية في هذه العلوم ولا تتطور من خلال تجمع علماء اسلاميين ملمين بالعلوم العصرية و القيام بتاسيس مبادئ جديدة و تطويره بل كما أن هناك بيئة ونظام ودولة احتضنت كل العلوم العصرية، العلوم الانسانية الاسلامية ايضا نشأة و تطورها تحتاج الى بيئة ومناخ ونظام ودولة تحتضنها و تنميه و تطوره و كلما كان هذه البيئة افضل و اقرب الى البيئة المثالية تنتج علوما أفضل وأنفع وأقرب للحقيقة الصافية و أبعد من الجشع والتوحش والطمع والهيمنة الأشرار ومن هذا المنطلق انظروا و قارنوا الى دور ابن حيان و ابن خلدون وابن سينا والخوارزمي و … في نشأة العلوم و تطويرها ليتجلى لنا البيئة والمناخ الضروري لنشأة علوم اسلامية و هي نفس العلوم العصرية. فاختلاف البيئة تحدد افضلية العلم وقربها من الحقيقة الصافية. و من هذا المنطلق نهتم بالرؤية الاسلامية لصناعة البيئة والمناخ والدولة المثالية أو المقبولة أو المتاحة ليكون العلوم فيها أقرب الى القواعد والاصول المطلوبة و هي تقع تحت عنوان “الولاية” في مراحلها وأشكالها المتنوعة . من كتاب العلوم الانسانية الاسلامية لمؤلفه محمد كورانب